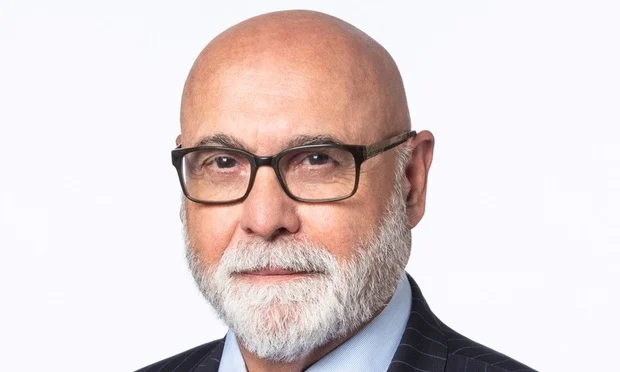العقوبات البديلة في التشريع المغربي 2025 - دراسة شاملة
- May 25, 2025
- []
تعريف العقوبات البديلة
العقوبات البديلة هي مجموعة الجزاءات غير السجنية التي يحكم بها القاضي في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبساً. تهدف هذه العقوبات إلى إصلاح المحكوم عليه وإعادة إدماجه في المجتمع دون سلب حريته، مع تجنب الآثار السلبية للسجن وما يترتب عليها من صعوبات في الاندماج الاجتماعي.
فهرس المحتويات
- مفهوم العقوبات البديلة وأهدافها
- أنواع العقوبات البديلة في المغرب
- شروط الاستفادة من العقوبات البديلة
- أسئلة شائعة حول العقوبات البديلة
- الإطار القانوني المغربي
- الدراسة الأكاديمية: العقوبات البديلة بين الفلسفة والواقع
- المراجع والمصادر
- مفهوم العقوبات البديلة وأهدافها
الأهداف الأساسية للعقوبات البديلة:
- الإصلاح والتأهيل: إعادة تأهيل المحكوم عليه وإدماجه في المجتمع بطريقة إيجابية دون عزله عن محيطه الاجتماعي والمهني.
- تخفيف الاكتظاظ: الحد من اكتظاظ السجون وما يترتب عليه من مشاكل اجتماعية واقتصادية وصحية.
- الفعالية الاقتصادية: تقليل التكاليف المالية لإدارة السجون وتحويل الموارد إلى برامج إصلاحية أكثر فعالية.
- أنواع العقوبات البديلة في المغرب
- العمل للمنفعة العامة: إلزام المحكوم عليه بأداء عمل غير مأجور لصالح جهة عمومية أو جمعية ذات منفعة عامة لمدة تتراوح بين 40 و240 ساعة.
- المراقبة الإلكترونية: وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية في مكان إقامته أو مكان محدد، مع إلزامه باحترام قيود زمنية ومكانية معينة.
- الغرامة النهارية: دفع مبلغ مالي يحدد بحسب الدخل اليومي للمحكوم عليه، ويتراوح عدد الأيام بين 10 و360 يوماً.
- الاختبار القضائي: وضع المحكوم عليه تحت المراقبة والإشراف لمدة محددة مع الالتزام بشروط معينة دون سلب حريته.
- الإفراج الشرطي: إطلاق سراح السجين قبل انتهاء مدة حكمه بشرط الالتزام بشروط معينة تحت إشراف مختص.
- إصلاح أضرار الجريمة: إلزام المحكوم عليه بتعويض الضحية أو المجتمع عن الأضرار الناتجة عن الجريمة المرتكبة.
- شروط الاستفادة من العقوبات البديلة
الشروط الأساسية:
- طبيعة الجريمة: أن تكون الجريمة جنحة لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبساً
- عدم العود: ألا يكون المحكوم عليه في حالة عود
- موافقة المحكوم عليه: قبول المحكوم عليه صراحة لتطبيق العقوبة البديلة
- تقدير المحكمة: اقتناع المحكمة بأن العقوبة البديلة ستحقق الأهداف المرجوة
- الظروف الشخصية: مراعاة الوضعية الاجتماعية والمهنية والصحية للمحكوم عليه
- أسئلة شائعة حول العقوبات البديلة
- ما هي العقوبات البديلة في القانون المغربي؟
- العقوبات البديلة هي مجموعة الجزاءات غير السجنية التي يطبقها القاضي بدلاً من العقوبات السالبة للحرية، وتشمل العمل للمنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامة النهارية، والاختبار القضائي.
- من يحق له الاستفادة من العقوبات البديلة؟
- يحق للمحكوم عليهم في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبساً، في غير حالات العود، وبشرط موافقة المحكوم عليه على تطبيق العقوبة البديلة.
- ما هي مدة العمل للمنفعة العامة؟
- تتراوح مدة العمل للمنفعة العامة بين 40 و240 ساعة، ويؤدى العمل لصالح جهة عمومية أو جمعية ذات منفعة عامة دون أجر.
- هل يمكن رفض العقوبة البديلة؟
- نعم، يحق للمحكوم عليه رفض العقوبة البديلة، وفي هذه الحالة يتم تنفيذ العقوبة الأصلية (السجن).
- ماذا يحدث في حالة عدم الالتزام بالعقوبة البديلة؟
- في حالة عدم الالتزام بشروط العقوبة البديلة أو مخالفتها، يتم إلغاؤها وتنفيذ العقوبة الأصلية (السجن).
- الإطار القانوني المغربي
النصوص القانونية الأساسية:
- مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي - المادة 35-1
- قانون المسطرة الجنائية - الكتاب السابع
- قانون تنظيم السجون - القانون رقم 23.98
- القانون المنظم للعمل للمنفعة العامة
التطورات التشريعية الحديثة 2025:
شهد المغرب في السنوات الأخيرة تطوراً مهماً في مجال العقوبات البديلة، حيث تم إدراج نصوص جديدة في مسودة مشروع القانون الجنائي تنص على توسيع نطاق هذه العقوبات وتحديد شروط تطبيقها بدقة، مما يعكس التوجه نحو سياسة جنائية حديثة تركز على الإصلاح والتأهيل.
الدراسة الأكاديمية:
شكل قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة خطوة هامة في مسار إصلاح النظام الجنائي المغربي. يسعى هذا القانون إلى استحداث بدائل للعقوبات الحبسية في بعض الجنح وذلك للحد من استخدام السجن وتعزيز فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع. ويركز القانون 43.22 على توفير إطار قانوني لتنفيذ العقوبات البديلة، مما يعكس تحولا نحو نظام عدالة جنائية أكثر مرونة وإنسانية.
ونظرا لفشل العقوبات السالبة للحرية لتحقيق أهدافها العقابية الرامية إلى الردع والإصلاح، وفي ظل الضغط المتزايد على السجون نتيجة ارتفاع أعداد المجرمين، باتت التشريعات العقابية الحديثة مضطرة إلى مراجعة استراتيجياتها. فقد سعت إلى استحداث أنظمة عقابية بديلة تتسم بالفعالية، تحقق الأهداف العقابية المعاصرة بأسلوب حضاري وبأقل التكاليف، مع مراعاة مصالح كل من المجرم والمجتمع. وتهدف هذه الأنظمة إلى إصلاح المجرم وتأهيله للاندماج في المجتمع، إلى جانب حماية المجتمع من مخاطر الجريمة. وتُعد العقوبات البديلة موضوعًا بالغ الأهمية من المنظورين النظري والعملي:
من الجانب النظري: تُعتبر العقوبات البديلة من الموضوعات الحديثة والمعاصرة التي استحوذت على اهتمام الفقهاء والباحثين في مجال الجريمة والعقاب. وقد أصبحت محور نقاش وجدل واسع في التشريعات المختلفة، بما فيها التشريع المغربي، حيث يسعى الجميع إلى تطوير السياسة الجنائية من خلال اعتماد هذه العقوبات كبديل للعقوبات الحبسية.
من الجانب العملي: تلعب العقوبات البديلة دورًا فعالًا في تحقيق أهداف العقاب ومكافحة الجريمة دون اللجوء إلى سلب حرية المجرمين، مما يجعلها ضرورة ملحة تستحق الدراسة والمتابعة. كما أنها تساعد في إصلاح المحكوم عليهم وتسهيل إعادة دمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتقليص الأعباء المالية التي تتكبدها الدولة لتغطية نفقات المساجين.
وامام هذه الأهمية، نجد موضوعنا ينطوي على إشكالية محورية تتمثل في كيف يمكن لأنواع العقوبات البديلة المختلفة، كما حددها القانون المغربي 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، أن تحقق أهداف العدالة الجنائية المتمثلة في الإصلاح والردع، مع ضمان حماية المجتمع وتخفيف الضغط على السجون.
وللإجابة عن هذه الإشكالية، نحتاج إلى التطرق إلى بعض التساؤلات الفرعية المهمة مثل ما هو مفهوم العقوبات البديلة؟
ماهي أهم أنواع العقوبات البديلة؟
المطلب الأول مفهوم العقوبات البديلة
تعرف العقوبة في الفقه الإسلامي بانها الجزاء المقرر شرعًا لمصلحة الجماعة على من يخالف أمر الشرع، سواء بارتكاب محظور أو ترك واجب. وهي جزاء مادي يُفرض مسبقًا لردع الجاني عن العودة إلى الجريمة. وبخصوص تعريفها القانوني المشرع المغربي، كغيره من التشريعات، لم يقدم تعريفًا محددًا للعقوبة، تاركًا ذلك للفقه القانوني. والفقه عرف العقوبة بأنها الجزاء الذي يحدده القانون ويوقعه القاضي على من تثبت مسؤوليته عن فعل يُعتبر جريمة قانونًا، فيصيب الجاني في شخصه، ماله، أو اعتباره.
وتعرف العقوبات البديلة في الفصل 35-1 انها “العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا”. وأول الملاحظات المرصودة أنه من النادر أن يتقدم المشرع بالتعريفات، لكن هنا ربما أراد يبعد كل التأويلات التي قد تتولد وسط الواقع العملي، لهذا يعكس هذا التعريف بوضوح نطاق تطبيق العقوبات البديلة، حيث يستثني الجنح التي تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، ويشير ضمنا إلى أن العقوبات البديلة تطبق على الأشخاص البالغين، وفقا لقانون المسطرة الجنائية الذي يحدد سن المسؤولية الجنائية في ثمانية عشر سنة، ويشدد على استبعاد العود من نطاق التطبيق.
وتختلف العقوبات البديلة عن غيرها من المفاهيم كما هو الحال بالنسبة للتدابير الوقائية فهي لا تُعتبر مبدئيًا عقوبات تُفرض على الشخص نتيجة ارتكابه جريمة، بل هي إجراءات تهدف إلى منع وقوع الجريمة أو تكرارها دون الحاجة إلى إدانة. أما العقوبات البديلة فهي جزاءات وضعها المشرع أمام القاضي لتحل بشكل ذاتي محل العقوبات السالبة للحرية وبالتالي، تفترض العقوبات البديلة اتخاذ إجراءات جنائية وصدور حكم قضائي يقضي بتطبيقها، مع التركيز على تجنب سلبيات الحبس في المؤسسات السجنية، مثل الاكتظاظ، التكاليف المادية، أو التأثيرات السلبية على نفسية المحكوم عليه.
كما تختلف العقوبات البديلة عن العقوبات الإضافية بكون هذه الأخيرة هي عقوبات تُضاف إلى العقوبة الأصلية، وتشمل الحد من الحقوق المدنية والسياسية وبعض الحقوق الأخرى التي يرى المشرع ضرورة تقييدها للمحكوم عليه. وقد عرفها المشرع المغربي في الفصل 14 من مجموعة القانون الجنائي المغربي بأنها عقوبات تُعتبر إضافية عندما لا يُصدر الحكم بها بمفردها، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية. كما حدد المشرع المغربي أنواع العقوبات الإضافية بشكل حصري في الفصل 36 من نفس القانون. ومن هنا، يتضح الفرق الجوهري بين العقوبات الإضافية والعقوبات البديلة؛ فالعقوبات البديلة تُعتبر عقوبات أصلية تُصدر بمفردها، وتحل محل العقوبات السالبة للحرية، بهدف تجنب سلبيات الحبس وتعزيز إعادة تأهيل المحكوم عليه.
وبالرجوع للمادة 3-35 نجدها تحدد لنا الجرائم التي لا يمكن الحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها أو لطبيعتها الخاصة، كالجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، الجرائم المالية، الاتجار في المخدرات، والاستغلال الجنسي للقاصرين الا ان المادة 4-35 امن نفس القانون تخول للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في الحكم بالعقوبات البديلة، حيث يمكنها استبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة إما تلقائيا أو بناء على طلب من النيابة العامة أو المدان أو دفاعه.
المطلب الثاني أنواع العقوبات البديلة
أولا: العمل لأجل المنفعة العامة.
إن اعتماد المشرع المغربي لنظام "العمل من أجل المنفعة العامة" كجزء من السياسة العقابية الحديثة، من خلال التنصيص عليه في القانون رقم 43.22، جاء نتيجة اقتناعه بأن الحبس ليس دائمًا الخيار الأنسب أو الأكثر فعالية في جميع الحالات. فالحبس قد لا يكون الوسيلة المثلى لتحقيق أهداف العقوبة المتمثلة في إصلاح الجاني، إعادة تأهيله، ودمجه في المجتمع. لذلك، منح المشرع القاضي صلاحية فرض عقوبات بديلة، مثل العمل من أجل المنفعة العامة، كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، بهدف تحقيق توازن بين معاقبة الجاني وإصلاحه. ومع ذلك، فإن هذا التوجه أثار بعض التحديات، سواء من حيث مواكبة التوجهات الحديثة للسياسة العقابية من جهة، أو من حيث التوفيق مع فلسفة حقوق الإنسان من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق بضمان كرامة المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة.
,ويُخصص الفرع الثاني من قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 لتنظيم "العمل لأجل المنفعة العامة" كأحد أشكال العقوبات البديلة، وفقًا لقواعد قانونية واضحة ومحددة. تنص المادة 5-35 على شرط أساسي لتطبيق هذه العقوبة، وهو أن يكون المحكوم عليه قد بلغ 15 سنة على الأقل عند صدور الحكم، مما يستبعد الأحداث دون هذا السن من تطبيق هذه العقوبة. وتُحدد المادة 6-35 طبيعة العمل المطلوب، حيث يجب أن يكون غير مدفوع الأجر، ويُنفذ لصالح جهات مثل مصالح الدولة، الجماعات الترابية، المؤسسات العامة، أو الجمعيات ذات النفع العام. كما تُحدد ساعات العمل بين 40 و3600 ساعة كحد أدنى وأقصى، مع معادلة تقضي بأن كل يوم من العقوبة الحبسية يُقابل بثلاث ساعات عمل، وذلك بناءً على معايير مثل خطورة الجريمة. وتُلزم المادة بمراعاة ملاءمة العمل مع جنس المحكوم عليه، سنه، مهنته، وحالته الصحية، لضمان تحقيق أهداف العقوبة دون التسبب بأي ضرر له.
ثانيا المراقبة الالكترونية
يُخصص الفرع الثالث من قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 لتنظيم "المراقبة الإلكترونية" كأحد أشكال العقوبات البديلة، من خلال مجموعة من النصوص التي تُحدد الإطار القانوني لتطبيقها. تنص المادة 10-35 على تعريف المراقبة الإلكترونية بأنها متابعة حركة وتنقلات المحكوم عليه باستخدام وسائل تكنولوجية محددة، مع تحديد معايير اختيار مكان ومدة المراقبة بناءً على عوامل مثل خطورة الجريمة، ظروف المحكوم عليه، وسلامة الضحايا.
ونظام المراقبة الإلكترونية، أو ما يُعرف بالسوار الإلكتروني، هو أحد أشكال العقوبات البديلة التي تُلزم المحكوم عليه أو المحبوس احتياطيًا بالإقامة في منزله أو محل إقامته خلال ساعات محددة، مع متابعة تحركاته باستخدام وسائل تكنولوجية. يتم ذلك من خلال وضع جهاز إرسال (سوار إلكتروني) على معصم أو ساق المحكوم عليه، يسمح لمركز المراقبة بتتبع موقعه والتأكد من وجوده في الزمان والمكان المحددين من قبل الجهة المسؤولة عن التنفيذ. يعتمد النظام على أجهزة كمبيوتر تُسجل نتائج هذه الاتصالات لضمان الامتثال للشروط.
وتوضح المادة 11-647 آلية تطبيق المراقبة الإلكترونية، حيث يتم وضع قيد إلكتروني على جسد المحكوم عليه (عادةً سوار في الكاحل أو المعصم) لرصد تحركاته ضمن الحدود الترابية المقررة. أما المادة 12-647 فتُحدد العقوبات المترتبة على الإخلال بشروط المراقبة، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر أو فرض غرامة مالية. وتشير المادة 13-647 إلى ضرورة إصدار نصوص تنظيمية لتوضيح كيفية تدبير المراقبة الإلكترونية، بما في ذلك المصاريف التي يمكن فرضها على المحكوم عليه. وأخيرًا، تتيح المادة 14-647 للمحكوم عليه طلب فحص طبي للتحقق من تأثير القيد الإلكتروني على صحته، مع إمكانية تعديل العقوبة البديلة بناءً على نتائج الفحص بقرار من قاضي تطبيق العقوبات.
ثالثا التدابير الرقابية والعلاجية كبدائل للعقوبات التقليدية
يُخصص الفرع الرابع من القانون رقم 43.22 لتنظيم "تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية" كأحد أنواع العقوبات البديلة. وفقًا للمادة 11-35، تُعرف "التدابير" بأنها مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى اختبار سلوك المحكوم عليه والتأكد من استعداده لتقويم سلوكه وإعادة إدماجه في المجتمع. وتُحدد المادة 12-35 أنواع التدابير التي يمكن للمحكمة فرضها، وتشمل: مزاولة نشاط مهني محدد، الإقامة في مكان معين، الخضوع للرقابة، التعهد بعدم الاتصال بضحايا الجريمة، الخضوع لعلاج نفسي، وتعويض الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتنص المادة 13-35 على أن الإدارة المكلفة بالسجون هي الجهة المسؤولة عن تتبع تنفيذ هذه التدابير، مع إعداد تقارير دورية حول مدى الالتزام بها. وفي حال إخلال المحكوم عليه بالتدابير المفروضة، تُحدد المادة ذاتها الإجراءات التي يتخذها قاضي تطبيق العقوبات، والتي قد تصل إلى تطبيق العقوبة الحبسية الأصلية كبديل.
.
رابعا الغرامة اليومية
يُخصص الفرع الخامس من القانون رقم 43.22 لتنظيم "الغرامة اليومية" كأحد أنواع العقوبات البديلة. وفقًا للمادة 14-35، تُعرف الغرامة اليومية بأنها مبلغ مالي يحدده القاضي عن كل يوم من مدة العقوبة الحبسية التي كان من الممكن فرضها. وتشترط هذه المادة، لتطبيق الغرامة اليومية، توفر صلح أو تنازل من الضحية، بالإضافة إلى تعويض المحكوم عليه للضرر الذي تسبب فيه.
وتُحدد المادة 15-35 الحد الأدنى والأقصى لمبلغ الغرامة اليومية، حيث يتراوح بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية، مع مراعاة معايير مثل الإمكانيات المادية للمحكوم عليه، خطورة الجريمة، والضرر الناتج عنها. كما توضح المادة ذاتها كيفية أداء الغرامة، حيث يُسمح بتقسيط المبلغ إذا كان المحكوم عليه غير معتقل، لتسهيل الالتزام بالدفع. وفي حال إخلال المحكوم عليه بأداء الغرامة، تُحدد المادة 15-35 الإجراءات التي يمكن أن يتخذها قاضي تطبيق العقوبات، والتي قد تصل إلى تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية كبديل.
ومع ذلك، يلاحظ أن المشرع اكتفى بتحديد أجل أداء الغرامة اليومية (اليوم الأخير من العقوبة الحبسية الأصلية) مع الإشارة إلى إمكانية التمديد، دون أن يوضح طريقة أداء هذه الغرامة بشكل دقيق. هذا يختلف عن الغرامة التقليدية التي تكون مستحقة فور اكتساب الحكم القوة التنفيذية. هذا الغموض قد يُضعف فعالية الغرامة اليومية كعقوبة بديلة، خاصة أن السماح بتمديد أجل الوفاء دون شروط واضحة قد يفتح الباب أمام فشل هذا البديل. كان من الأفضل أن يُلزم المشرع المحكوم عليه بتقديم ما يثبت عجزه المادي عند طلب التمديد، أو أن يمنح قاضي تطبيق العقوبات سلطة تقديرية لتخفيض قيمة الغرامة في حال تبين صلاح المحكوم عليه وعسره المالي، لضمان تحقيق العدالة وتجنب تحويل العقوبة إلى عبء لا يمكن تحمله.
خاتمة
- اكتسبت العقوبات البديلة مكانة بارزة وأهمية كبيرة ضمن منظومة العدالة الجنائية، رغم وجود بعض السلبيات والتحديات التي رافقت تطبيقها. جاء ذلك نتيجة فشل العقوبات السالبة للحرية في تحقيق أهدافها الردعية والإصلاحية، حيث أظهرت محدوديتها في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في المجتمع، بل وفاقمت في كثير من الأحيان من المشكلات الاجتماعية. فقد أثبتت التجارب أن الحبس غالبًا ما يؤدي إلى تفاقم السلوك الإجرامي بدلاً من تقويمه، نتيجة ظاهرة الاكتظاظ في السجون، وما يترتب عليها من مساوئ مثل سوء الأوضاع الصحية والنفسية للسجناء، فضلاً عن اختلاط المجرمين المبتدئين بالمجرمين المعتادين، مما يحول السجون إلى بيئة تُعزز الإجرام بدلاً من الحد منه.
لذلك، أصبحت العقوبات البديلة الخيار الأنسب لمعالجة هذه الإشكاليات، حيث أظهرت نجاحًا ملحوظًا في ضبط السلوكيات الإجرامية خارج أسوار السجون، دون الحاجة إلى سلب حرية المحكوم عليه. تهدف هذه العقوبات إلى تحقيق الإصلاح والتأهيل في بيئة اجتماعية طبيعية، مع تجنب الآثار السلبية للحبس، مثل الوصمة الاجتماعية التي تُصيب المحكوم عليه وأسرته. كما تساهم في الحد من ظاهرة الاكتظاظ في السجون، وتخفيف العبء المالي على الدولة الناتج عن تكاليف الإنفاق على المؤسسات السجنية. وقد دفع هذا التوجه العديد من التشريعات حول العالم إلى الابتعاد تدريجيًا عن العقوبات السالبة للحرية، واعتماد العقوبات البديلة كجزء من سياسة عقابية حديثة تركز على العدالة التصالحية والإصلاحية. المغرب، على الرغم من تأخره في تبني هذا النهج مقارنة ببعض الدول، قد خطا خطوة مهمة من خلال إصدار القانون 43.22 الذي نظم العقوبات البديلة وجعلها جزءًا من منظومته القانونية.
من إنجاز الطالب :
سفيان الباشوري